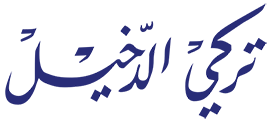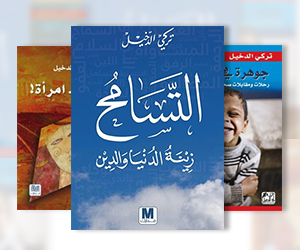وَمَا زِلْنَا نَعْرِضُ أَعْجَازَ أَبْيَاتِ شِعْرٍ لِأَبِي الطَّيِّبِ الْمُتَنَبِّي، سَارَتْ أَمْثَالاً، فَقَدْ أَقَرَّ الْمُحِبُّ وَالْمُبْغِضُ بِأَنَّ مِنْ مَزَايَا شِعْرِ أَبِي الطَّيِّبِ، إِرْسَالَ الْمَثَلِ فِي أَنْصَافِ الْأَبْيَاتِ…
(146) وَأَعْيَا دَوَاءُ المَوْتِ كُلَّ طَبِـيْـبِ
الموتُ هو الحقيقةُ الكونيةُ الكُبرَى، التي تصدمُ الإنسانَ، وتفجَعُهُ، رُغمَ تَسلِيمِهِ بهَذِهِ الحقيقةِ، إَلَّا أَنَّهَا لَا تَتَوَقَفُ عَنْ مُبَاغَتَتِهِ وَمُفَاجَأَتِهِ. وَحْدَهُ المَوْتُ يُعِيدُ ابن آدَمَ إلى حَجمِهِ الطبيعي، بَعدَ أَن جعلَتهُ الحيَاةُ يَتَكَبَّرُ وَيَتَبَخْتَرُ، ولذلك قالوا: الموتُ يفضحُ الدنيا، ومن أسماءِ الموتِ: «هادمُ اللذاتِ»، كُلَّمَا ازدادَ تعجرفُ الإنسانِ وتجبرُه وتكبرُه، دَلَّ ذلكَ على انغماسِه في الدُنيَا أكثر، وتَمَادِيهِ في غَيِّهِ، ونِسيَانِهِ المصيرَ المحتومَ، الذي لا مَفَرَّ مِنهُ. رأى الإنسانُ خلالَ تاريخِه أن الأطباءَ يُخَفِفونَ الآلامَ، ويُعالجونَ الأمراضَ، ولا ألمَ يَقُضُّ مضجعَه كالموتِ، فأوكلَ مهمةَ البحثِ عنْ علاجِ الموتِ إلى الأطباءِ، وأجهد كُلُّ طبيبٍ عُمرَهُ، في البحثِ عن الدواءِ وصناعةِ التِّرْيَاقِ، فكان جهدُهم مرضاً وعملهم إعياءً، كما قال أبو الطيب: وَأَعْيَا دَوَاءُ المَوْتِ كُلَّ طَبِيْبِ (أَعْيَا): أَعْجَزَ. وَدَاءٌ أَعْيَا الأَطِبَّاءَ؛ مَرَضٌ مُسْتَعْصٍ على الشِّفَاءِ، لَا يُرجَى بُرؤه، لا عِلاجَ لهُ، ولَا شِفَاءَ مِنهُ. أَعْجَزَهُم عَنْ مُدَاوَاتِهِ حَتَّى اليَأس! وبلغَ يقينُ المتنبي بالموتِ، أنه اعتبرَ الناسَ أبناءَ الموتى، ولا شيءَ كموتِ الآباءِ يُقنِعُ بالحقيقةِ الأبناءَ… مُستغرباً رفضَ الناسِ وهوَ منهم تجرّعَ كَأسَ الموتِ التي تجرعَها الآباءُ، ولا بدَّ من شربِها:
نَحْنُ بَنُو المَوتَى فَمَا بَالُنَا * نَعَافُ مَا لَا بُدَّ مِنْ شُرْبِهِ
وجّهَ الشاعرُ الخطابَ لنفسهِ ومن معه وأشركَ نفسَه مع المجموعةِ التي أراد انتقادَها وإبداءَ ملاحظةٍ عليها، ابتعاداً عن التعالي بنصيحةِ الآخرين، وهوَ أسلوبٌ ممجوجٌ يَنْفُرُ مِنْهُ المتلقي، لإحساسهِ أنَّ الناصحَ استبطنَ وضعَ نفسهِ في مرتبةٍ عُليا بالمقارنة مع المنصوحين، بدلالة أنه ينصحَهم، إذ هو مستوعبٌ للنصيحةِ عارفٌ خبَاياها متجاوزٌ المنصوحينَ، ولذلكَ يَنصحهمْ.
عِندما ينصحُ يجعلُ الشاعرُ نفسَه بين الناسِ ويُبْدي ملاحظةً عليهم، وهوَ منهم، فهذا يجعله ناصحاً أميناً لا متكبراً متعالياً، وهذا أحرى لقبولِ المنصوحين للنصيحةِ واستفادتِهم منها وامتثالِهم لِما فيها من توجيهٍ ونحوِه.
ويحكي المتنبي أن شيئاً لم يسلمْ من اختلافِ الناسِ عليه، فكأنهم على إثرِ ذلك لم يجتمعوا مُتفقين على شيءٍ، سوى اتفاقِهم على الموتِ؛ الأمرُ الوحيدُ الذي اتفقَ البشرُ عليه!
تَخَالَفَ النَّاسُ حَتَّى لَا اتِّفَاقَ لَهُم * إِلَّا عَلَى شَجَبٍ والخُلْفُ فِي الشَّجَبِ
الشَّجَبُ: الهَلاكُ وهو الموتُ. ورغم اتفاقِهم على حدوثِ الموتِ اختلفوا في صفتِه، بين قائلٍ بموتِ الجسمِ وحياةِ الروحِ، وقائلٍ بموتِهما معاً. ومن حقائقِ الموتِ أنه لا يُعَرَّى من الموتِ أحدٌ، أي لا يُخَلَّصُ.
يقولُ المتنبي، داعياً للشجاعةِ في مواجهةِ المحتومِ:
إذا لمْ يَكنْ من الموتِ بُدٌّ فَمِنَ العَارِ أَن تَمُوتَ جَبَانَا
وقال: إذا تأملتَ الزمانَ وصرَفَه * تيقنتَ أَنَّ الموتَ ضَرْبٌ من القَتْلِ وقال أيضاً: نبكي على الدُنيا وما مِن معشَرٍ * جَمَعَتْهُم الدُّنيَا وَلَم يَتَفَرّقُوا
ويريدُ بالتفرقِ الموتَ. ولذلك فمِنْ أسماءِ الموتِ، كما سمّاهُ النبيُ صلى الله عليه وسلم في الحديث: «هادمَ اللذاتِ». ومن أسماءِ الموتِ أيضاً: «مُفَرِّقُ الجماعاتِ».
ومن مفارقاتِ الموتِ وغرائبِهِ ما شرحهُ بيتُ الفخر الرازي، القائل:
المَرْءُ مَا دَامَ حَيَّـاً يُسْتَهَانُ بِهِ * ويَعظمُ الرُّزْءُ فِيْهِ حِيْنَ يُفقَدُ
وما أكثرُ ما نستهينُ ونغفلُ ونصدُّ عمن حولِنَا وقربِنَا وفي دوائرِنَا، ولا نفطنْ لأهميتِهم إلا حينَ نفتقدَهُم بالموتِ! ولذلك قالَ الشاعرُ يَعظمُ الرُّزْءُ فيه: أي تَعظُمُ المصيبةُ التي نزلتَ به بخصوصِ فقدِ هذا المرءِ. وللمتنبي أبياتٌ كثيرةٌ عن الموتِ يتناولَها من زوايا مختلفةٍ، فَمِنْ ذلكَ قوُلهُ:
لولا مفارقةُ الأحبابِ ما وجدتْ * لها المنايا إلى أرواحِنا سُبُلَا
وقالَ: فالموتُ آَتٍ والنفوسُ نفائسٌ * والمُستَغِرُ بِمَا لديهِ الأحمقُ
قال أبو ذؤيب الهذلي في بيانِ صفةِ نزولِ الموتِ، والمنيةُ هي الموتُ:
وَإِذَا المَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا * أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيْمَةٍ لَا تَنْفَعُ
وعقدَ الجاحِظُ في (المحاسن والمساوئ)، باباً أسْماهُ: (محاسنَ الموتِ)، وفيه قالَ: (محاسنُ الموتِ في الحديثِ المرفوعِ: «الموتُ راحةٌ»).
وقالَ بعضُ السلفِ: ما من مؤمنٍ إلا والموتُ خيرٌ له مِنْ الحياةِ، لأنه إنْ كانَ مُحسناً، فاللهُ يقولُ: (وَما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ). وإنْ كان مسيئاً، فالله تعالى يقولُ أيضاً: (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً). قالت الفلاسفةُ: «لا يِستكملُ الإنسانُ حدَّ الإنسانيةِ إلا بالموتِ، لأنَّ حدَّ الإنسانيةِ أنَّهُ حَيٌّ نَاطِقٌ مَيِّتٌ».
وعِلمُ التعريفاتِ يُسمَّى علمُ وضعِ الحدودِ للشيء الذي يُعَرُّفُ، وببيانِ حدودِه يتميزُ شكلُه، ويتباينُ عن غيرِه. ومقولةُ الفلاسفةِ السابقةِ وضعوا بها تعريفاً للإنسانِ، وحدودُه التي تُميزهُ عنْ غيرهِ ثلاثةٌ:
1- أنهُ حيٌ. وهذَا الحَدُّ يخرجُ به من التعريفِ كلُّ ما ليسَ بحيٍّ كالجماداتِ والنباتاتِ، وكلُّ ما ليسَ فيهِ روحٌ.
2- أنه ناطِقٌ، وهذا الحدُّ يُخرجُ من التعريفِ الحيواناتِ والنباتاتِ. ويُسَمِّي الفلاسفةُ الإنسانَ الحيوانَ الناطقَ، فالنطقُ يُفرِّقُهُ عنْ الحيواناتِ من البهائمِ والسباعِ، وقولُهمْ حيوانٌ، ليس تشبيهاً بالبهائمِ من الحيواناتِ، بل هو اشتقاقٌ من الحياةِ، ومنه قولُه تعالى في القرآنِ الكريمِ: (وإنّ الدارَ الآخرةَ لهي الحيوانُ).
وثالثُ حدودِ تعريفِ الإنسانِ هي أن يموتَ. واعتبرَ أهلُ الهِمَمِ العاليةِ بعضَ الأحياءِ أمواتاً، فقالَ شاعرُهم:
ليسَ منْ ماتَ فاستراح بميِّتٍ * إنما الميِّتُ ميِّتُ الأحياءِ